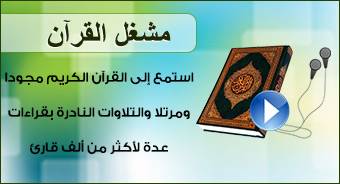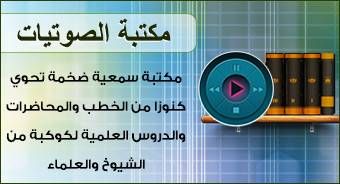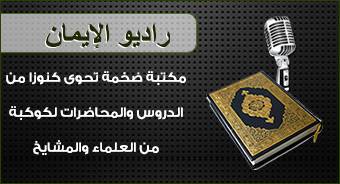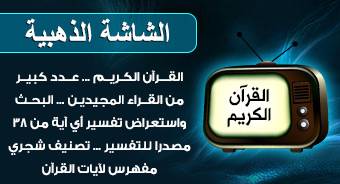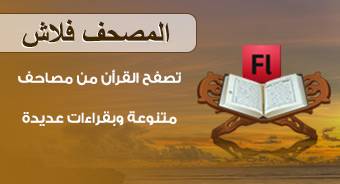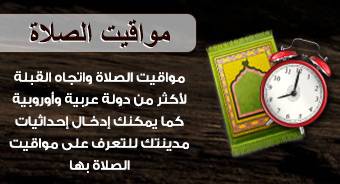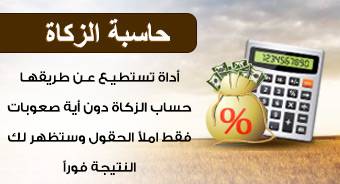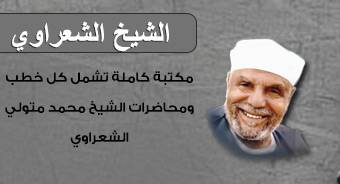|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صبح الأعشى في كتابة الإنشا (نسخة منقحة)
الجملة الثانية في أول من وضع الشكل:وقد اختلفت الرواية في ذلك على ثلاث مقالأت، فذهب بعضهم إلى أن المبتديء بذلك أبو الأسود الدؤلي، وذلك أنه أراد أن يعمل كتاباً في العربية يقوم الناس به ما فسد من كلامهم؛ إذا كان ذلك قد فشا في الناس.فقال: أرى أن أبتديء بإعراب القرآن أولاً، فأحضر من يمسك المصحف، وأحضر صبغاً يخالف لون المداد. وقال للذي يمسك المصحف عليه: إذا فتحت فاي فاجعل نقطةً فوق الحرف، وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة تحت الحرف، وإذا ضممت فاي فاجعل نقطةً أمام الحرف، فإن اتبعت شيئاً من هذه الحركات غنة يعني تنويناً فاجعل نقطتين. ففعل ذلك حتى أتى على آخر المصحف.وذهب آخرون إلى أن المبتديء بذلك نصر بن عاصم الليثي، وأنه الذي خمسها وعشرها.وذهب آخرون إلى أن المبتديء بذلك يحيى بن يعمر.قال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه الله: وهؤلاء الثلاثة من جلة تابعي البصريين.وأكثر العلماء على أبا الأسود جعل الحركات والتنوين لا غير، وأن الخليل بن أحمد هو الذي جعل الهمز والتشديد والروم والأشمام.الجملة الثالثة في الترغيب في الشكل والترهيب عنه:وقد اختلف مقاصد الكتاب في ذلك، فذهب بعضهم إلى الرغبة فيه، والحث عليه، لما فيه من البيان والضبط والتقييد.قال هشام بن عبد الملك: اشكلوا قرائن الأداب، لئلا تند عن الصواب. وقال علي بن منصور: حلوا غرائب الكلم بالتقييد، وحصنوها عن شبه التصحيف والتحريف.ويقال: إعجام الكتب يمنع من استعجامها، وشكلها يصونها عن إشكالها، ولله القائل: وذهب بعضهم إلى كراهته، والرغبة عنه.قال سعيد بن حميد الكاتب: لأن يشكل الحرف على القارىء أحب إلي من أن يعاب الكاتب بالشكل.ونظر محمد بن عباد إلى أبي عبيد وهو يقيد البسملة فقال: لو عرفته ما شكلته. وقد جرد الصحابة رضوان الله عليهم المصحف حين جمعوا القرآن من النقط والشكل وهو أجدر بهما، فلو كان مطلوباً لما جردوه منه.قال الشيخ أبو عمرو الداني: وقد وردت الكراهة بنقط المصاحف عن عبد الله بن عمر، وقال بذلك جماعة من التابعين.واعلم أن كتاب الديونة لا يعرجون على النقط والشكل بحال، وكتاب الإنشاء منهم من منع ذلك محاشاة للمكتوب إليه عن نسبته للجهل بأنه لا يقرأ إلا ما نقط أو شكل، ومنهم من ندب إليه، للضبط والتقييد كما تقدم.والحق التفريق في ذلك بين ما يقع فيه اللبس ويتطرق إليه التحريف لعلاقته أو غرابته، وبين ما تسهل قراءته لوضوحه وسهولته.وقد رخص في نقط المصاحف بالأعراب جماعة: منهم ربيعة بن عبد الرحمن، وابن وهب، وصرح أصحابنا الشافعية رضي الله عنهم بأنه يندب نقط المصحف وشكله؛ أما تجريد الصحابة رضوان الله عليهم له من ذلك فذلك حين ابتداء جمعه حتى لا يدخلوا بين دفتي المصحف شيئاً سوى القرآن، ولذلك كرهه من كرهه.وأما أهل التوقيع في زماننا فإنهم يرغبون عنه خشية الأظلام بالنقط والشكل إلا ما فيه إلباس على ما مر؛ وأهل الديونة لا يرون بشيء من ذلك أصلاً ويعدون ذلك من عيوب الكتابة وإن دعت الحاجة إليه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.الجملة الرابعة فيما ينشأ عنه الشكل ويترتب عليه:واعلم ان الشكل جار مع الأعراب كيفما جرى، فينقسم إلى السكون وهو الجزم، وإلى الفتح وهو النصب، وإلى الضم وهو الرفع، وإلى الجر وهو الخفض.أما السكون فلأنه الأصل. وأما الحركات الثلاث فقد قيل إنها مشاكلة للحركات الطبيعية: فالرفع مشاكل لحركة الفلك لارتفاعها، والجر مشاكل لحركة الأرض والماء لانخفاضها، والنصب مشاكل لحركة النار والهواء لتوسطها؛ ومن ثم لم يكن في اللغة العربية أكثر من ثلاثة أحرف بعدها ساكن إلا ما كان معدولاً.فسبحان من أتقن ما صنع! ثم الذي أكثر النحاة أن الحركات الثلاث مأخوذة من حروف المد واللين وهي الألف، والواو، والياء، اعتماداً على أن الحروف قبل الحركات، والثاني مأخوذة من الأول، فالفتحة مأخوذة من الألف إذ الفتحة علامة النصب في قولك: رأيت زيداً، ولقيت عمراً، وضربت بكراً؛ والألف علامة النصب في الأسماء المعتلة المضافة كقولك: رأيت أباك، وأكرمت خالك؛ ويكون إطلاقاً للروي المنصوب كقولك: المذهبا، وأنت تريد المذهب، فلما أشبعت الفتحة نشأت عنها الألف؛ والكسرة مأخوذة من الياء لأنها أختها ومن مخرجها، والكسرة علامة الخفض في قولك: مررت بزيد، وأخذت عن زيد حديثاً؛ والياء علامة الخفض أيضاً في الأسماء المعتلة المضافة كقولك: مررت بأبيك وأخيك وذي مال؛ والضمة من الواو لأنها من مخرجها: من الشفتين، وهي علامة الرفع في قولك: جاءني زيد، وقام عمرو، وخرج بكر، والواو علامة الرفع في الأسماء المعتلة المضافة كقولك: جاءني أخوك وأبوك وذو مال.وذهب بعض النحاة إلى أن هذه الحروف مأخوذة من الحركات الثلاث، الألف من الفتحة، والواو من الضمة، والياء من الكسرة اعتماداً على أن الحركات قبل الحروف، بدليل أن هذه الحروف تحدث عند هذه الحركات إذا أشبعت، وأن العرب قد استغنت في بعض كلامها بهذه الحركات عن هذه الحروف اكتفاءً بالأصل عن الفرع: لدلالة الأصل على فرعه.وذهب آخرون إلى أن الحروف ليست مأخوذةً من الحركات، ولا الحركات مأخوذة من الحروف، اعتماداً على أن أحدهما لم يسبق الأخر، وصححه بعض النحاة.الجملة الخامسة في صور الشكل ومحال وضعه على طريقة المتقدمين والمتأخرين:واعلم أن المتقدمين يميلون في الشكل غالب الصور إلى النقط بلون يخالف لون الكتابة.وقال الشيخ أبو عمر الداني رحمه الله: ورأى أن يستعمل للنقط لونان: الحمرة والصفرة، فتكون الحمرة للحركات، والتنوين، والتشديد، والتخفيف، والسكون، والوصل، والمد، وتكون الصفرة للهمزة خاصة.قال: وعلى ذلك مصاحف أهل المدينة. ثم قال: وإن استعملت الخضرة للابتداء بألفات الوصل على ما أحدثه أهل بلادنا، فلا أرى بذلك بأساً. قال: ولا أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم.وقد وردت الكراهة لذلك عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من علماء الأمة.وأما المتأخرون فقد أحدثوا لذلك صوراً مختلفة الأشكال لمناسبة تخص كل شكل منها، ومن أجل اختلاف صورها وتباين أشكالها رخصوا في رسمها بالسواد. ويتعلق بالمقصود من ذلك سبع صور:الأولى: علامة السكون:والمتقدمون يجعلون علامة ذلك جرةٌ بالحمرة فوق الحرف، سواء كان الحرف المسكن همزة كما في قولك: لم يشأ، أو غيرها من الحروف كالذال من قولك: اذهب.أما المتأخرون: فإنهم رسموا لها دائرة تشبه الميم إشارة إلى الجزم إذ الميم آخر حرف من الجزم، وحذفوا عراقة الميم استخفافاً، وسموا تلك الدائرة جزمة، أخذاً من الجزم الذي هو لقب السكون، ويحتمل أن يكونوا أتوا بتلك الدائرة على صورة الصفر في حساب الهنود ونحوهم إشارة إلى خلو تلك المرتبة من الأعداد لأن الصفر هو الخالي، ومنه قولهم صفر اليدين بمعنى أنه فقير ليس في يديه شيء من المال.وحذاقق الكتاب يجعلونها جيماً لطيفة بغير عراقة إشارة إلى الجزم.الثانية: علامة الفتح:أما المتقدمون فإنهم يجعلون علامة الفتح نقطةً بالحمرة فوق الحرف، فإن أتبعت حركة الفتح تنويناً، جعلت نقطتين، إحداهما للحركة، والأخرى للتنوين.والمتأخرون يجعلون علامتها ألفاً مضطجعة، لما تقدم من أن الألف علامة الفتح في الأسماء المعتلة ورسموها بأعلى الحرف موافقة للمتقدمين في ذلك، وسموا تلك الألف المضطجعة نصبه أخذاً من النصب، ويجعلون حالة التنوين خطتين مضطجعتين من فوقه كما جعل المتقدمون لذلك نقطتين، وعيروا عن الخطتين بنصبتين.قال الشيخ عماد الدين بن الفيف رحمه الله: ويكون بينهما بقدر واحدة منهما.الثالثة: علامة الضم:أما المتقدمون فإنهم يجعلون علامة الضمة نقطة بالحمرة وسط الحرف أو أمامه، فإن الحق حركة الضم تنوين، رسموا لذلك نقطتين: إحداهما للحركة، والأخرى للتنوين على ما تقدم في الفتح.وأما المتأخرين فإنهم يجعلون علامة الضمة واواً صغيرة، لما تقدم أن الواو من علامة الرفع في الأسماء المعتلة، وسموها رفعة لذلك، ورسموها بأعلى الحرف ولم يجعلوها في وسطه كيلا تشين الحرف، بخلاف المتقدمين لمخالفة اللون ولطافة النقطة.فإن الحق حركة الضم تنوينٌ رسموا لذلك واواً صغيرة بخطة بعدها: الواو إشارة للضم، والخطة إشارة للتنوين، وعبروا عنهما برفعتين.وبعضهم يجعل عوض الخطة واواً أخرى مردودة الأخر على رأس الأولى.الرابعة: علامة الكسر:والمتقمون يجعلون علامة الجرة نقطة بالحمرة تحت الحرف. فإن لحق حركة الكسر تنوين رسموا لذلك نقطتنين.والمتأخرون جعلوا علامة الكسر شظيةً من أسفل الحرف إشارة إلى الياء التي هي علامة الجر في الأسماء المعتلة على ما مر، وسموا تلك الشظية خفضةً، أخذاً من الخفض الذي هو لقب الكسر، ولم يخالفوا بينها وبين علامة النصب لاختلاف محلهما.فإن لحق حركة الكسر تنوين رسموا له خطتين من أسفله: إحداهما للحركة، والأخرى للتنوين.الخامسة: علامة التشديد:والمتقدمون اختلفوا: فمذهب أهل المدينة أنهم يرسمون علامة التشديد على هذه الصورة ولا يجعلون معها علامات الأعراب بل يجعلون علامة الشد مع الفتح فوق الحرف، ومع الكسر تحت الحرف، ومع الضم أمام الحرف.قال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه الله: وعليه عامة أهل بلدنا.قال: ومنهم من يجعل مع ذلك نقطةً علامة للإعراب، وهو عندي أحسن.وعامة أهل الشرق على أنهم يرسمون علامة التشديد صورة شين من غير عراقة على هذه الصور، كأنهم يريدون أول شديد، ويجعلون تلك العلامة فوق الحرف أبداً ويعربونه بالحركات، فإن كان مفتوحاً جعلوا مع الشدة نقطة فوق الحرف علامة الفتح، وإن كان مضموماً جعلوا مع الشدة نقطة أمام الحرف علامة الضم، وإن كان مكسوراً جعلوا مع الشدة تحت الحرف علامة الكسر.وعلى هذا المذهب استقر رأي المتأخرين أيضاً؛ غير أنهم يجعلون بدل النقط الدالة على الأعراب علامات الأعراب التي اصطلحوا عليها من النصبة، والرفعة، والخفضة، فيجعلون النصبة والرفعة بأعلى الشدة، ويجعلون الخفضة بأسفل الحرف الذي عليه الشدة، وبعضهم يجعلها أسفل الشدة من فوق الحرف. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المشدد من كلمة واحدة أو من كلمتين كالأدغام من كلمتين.السادسة: علامة الهمزة:والمتقدمون يجعلونها نقطة صفراء ليخالفوا بها نقط الأعراب كما تقدم في كلام الشيخ أبي عمرو الداني رحمه الله، ويرسمونها فوق الحرف أبداً، إلا أنهم يأتون معها بنقط الأعراب الدالة علىالسكون والحركات الثلاث بالحمرة على ما تقدم، وسواء في ذلك كانت صورة الهمزة واواً أو ياءً وألفاً؛ إذ حق الهمزة أن تلزم مكاناً واحداً من السطر، لأنها حرف من حروف المعجم.والمتأخرون يجعلونها عيناً بلا عراقة، وذلك لقرب مخرج الهمزة من العين، ولأنها تمتحن بها كما سيأتي.ثم إن كانت الهمزة مصورة بصورة حرف من الحروف، فإن كانت الهمزة ساكنة، جعلت الهمزة من أعلى الحرف مع جزمة بأعلاها.وإن كانت مفتوحة، جعلت بأعلى الحرف أيضاً مع نصبة بأعلاها. وإن كانت مضمومة، جعلت بأعلى الحرف مع رفعة بأعلاها. وإن كانت مسكورة، جعلت بأسفل الحرف مع خفضة بأسفلها، وربما جعلت بأعلى الحرف والخفضة بأسفله.وقد اختلف القدماء من النحويين في أي الطرفين من اللام هي الهمزة، فحكي عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال: الطرف الأول هو الهمزة، والطرف الثاني هو اللام.قال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه الله: وإلى هذا ذهب عامة أهل النقط؛ واستدلوا على صحة ذلك بأن رسم هذه الكلمة كانت أولاً لاماً مبسوطة في طرفها ألف على هذه الصورة لا كنحو رسم ما أشبه ذلك مما هو على حرفين من سائر حروف المعجم مثل يا، وها، وما أشبههما إلا أنه استثقل رسم ذلك في اللام ألف خاصة لاعتدال طرفيه لمشابهة كتابة الأعاجم فحسن رسمه بالتضفير فضم أحد الطرفين إلى الأخر فأيهما ضم إلى صاحبه كانت الهمزة ضرورةً.وتعتبر حقيقة ذلك بأن يؤخذ شيء من خيط ونحوه فيضفر ويخرج كل واحد من الطرفين إلى جهة، ثم يقام الطرفان فيتبين من الوجهين أن الأول هو الثاني في الأصل، وأن الثاني هو الأول لا محالة في التضفير.وأيضاً فقد اتفق أهل صناعة الخط من الكتاب القدماء وغيرهم على أنه يرسم الطرف الأيسر قبل الطرف الأيمن، ولا يخالف ذلك إلا من جهل صناعة الرسم إذ هو بمنزلة من ابتدأ برسم الألف قبل الميم في ما وشبهه مما هو على حرفين، فثبت بذلك أن الطرف الأول هو الهمزة، وأن الطرف الثاني هو اللام، إذ الأول في أصل القاعدة هو الثاني، والثاني هو الأول على ما مر؛ وإنما اختلف طرفاها من أحل التضفير.وخالف الأخفش، فزعم أن الطرف الأول ههو اللام، والطرف الثاني هو الهمزة، واستشهد لذلك بأن ما تلفظ هو المرسوم أولاً وما تلفظ به آخراً هو المرسوم آخراً، ونحن إذا قرأنا لأنت ولأنه ونحوهما لفظنا باللام أولاً ثم بالهمزة بعدها.ونازعه في ذلك الشيخ أبو عمر الداني. والحق أن ذلك يختلف باختلاف اللام ألف على ما رتبه متأخرو الكتاب الآن، ففي المضفورة على ما تقدم، وفي المصورة بهذه الصورة لا بالعكس.وإن كانت الهمزة غير مصورة بحرف من الحروف كالهمزة في جزء وخبءٍ، جعلت العلامة في محل الهمزة من الكلمة مع علامة الأعراب: من سكون، وفتح، وضم، وكسر.فإن عرض للهمزة مع حركة من الحركات الثلاث تنوينٌ، جعل مع الهمزة علامة التنوين، من نصبتين أو رفعتين أو خفضتين على ما مر في غير الهمزة.قال الشيخ أبو عمرو الداني رحمه الله: وتمتحن الهمزة في موضعها من الكلام بالعين، فحيث وقعت العين وقعت الهمزة مكانها، وسواء كانت متحركة أو ساكنة لحقها التنوين أو لم يلحقها.فتقول في آمنوا عامنوا، وفي وآتى المال وعاتى المال، وفي مستهزئين مستهزعين، وفي خاسئين خاسعين، وفي مبرئون مبرعون، وفي متكئون متكعون، وفي ماء ماع، وفي سوء سوع، وفي أولياء أولياع، وفي تنوء تنوع، وفي لتنوء لتنوع، وفي أن تبوأ أن تبوعا، وفي تبوء تبوع، وفي من شاطيء من شاطع، وكذلك ما أشبهه حيث وقع فالقياس فيه مطرد.السابعة: علامة الصلة في ألفات الوصل:أما المتقدمون فإنهم رسموا لها جرةً بالحمرة في سائر أحوالها، وجعلوا محلها تابعاً للحركة التي قبل ألف الوصل. فإن وليها فتحة كما في قوله تعالى: {تتقون * الذي} جعلت الصلة جرّة حمراء على رأس الألف على هذه الصورة ( آ ) وإن وليها كسرة كما في قوله تعالى: {رب العالمين} جعلت الصلة جرّة تحت الألف على هذه الصورة ( ا ) وإن وليها ضمة كما في قوله تعالى: {نستعين * اهدنا} جعلت الصلة جرّة حمراء في وسطها على هذه الصورة، فإن لحق شيئاً من الحركات التنوين جعلت الصلة أبداً تحت الألف، لأن التنوين مكسور للساكنين ما لم يأت بعد الساكن الواقع بعد ألف الوصل ضمةٌ لازمة نحو قوله تعالى: {فتيلاً * انظر} و{عيون * ادخلوها}. قال بعضهم: يضم التنوين فتجعل الجرّة على ذلك في وسط الألف.وأما المتأخرون فإنهم رسموا لذلك صاداً لطيفة إشارة إلى الوصل وجعلوها بأعلى الحرف دائماً ولم يراعوا في ذلك الحركات، اكتفاءً باللفظ.تنبيه:قد تقدم في....... الأول من الهجاء أن اللفظ قد يتعين في الهجاء إلى الزيادة والنقصان، ولا شك أن الشكل يتغير بتغير ذلك، ونحن نذكر من ذلك ما يختص بالهجاء العرفيّ دون الرسميّ باعتبار الزيادة والنقص.أما الزيادة، فمثل أولئك، وأولو، وأولات ونحوها.قال الشيخ أبو عمر والدانيّ: وسبيلك أن تجعل علامة الهمزة نقطة بالصّفرة في وسط ألف أولئك وأولو وأولات، وتجعل نقطة بالحمرة أمامها في السطر لتدل على الضمة. قال: وإن شئت جعلتها في الواو الزائدة لأنها صورتها، وهو قول عامّة أهل النقط. هذه طريقة المتقدمين.أما المتأخرون، فإنهم يجعلون علامة الهمزة على الواو وهو مخالف لما تقدم من اعتبار الهمزة بالعين فإنها لو امتحنت بالعين، لكان لفظها عولئك وكذلك البواقي.وأما النقص فمثل النبئين إذا كتبت بياء واحدة، وهؤلاء، ويا آدم إذا كتبنا بحذف الألف بعد الهاء في هؤلاء والألف الثانية في يا آدم فترسم علامة الهمزة من النقطة الصفراء وحركتها على رأي المتقدمين، وصورة العين على رأي المتأخرين قبل الياء الثانية في النبيين، وتجعل ذلك على الألف الثانية في يا آدم لأنها صورتها وعلى الواو في هؤلاء لأنها صورتها.ووراء ما تقدّم من الشكل أمور تتعلق بالأدغام، والأظهار، والأخفاء، والأقلاب، والمدّ، وغيرها من متعلقات القراءة ليس هذا موضع ذكرها؛ والله أعلم.فائدة:قال الشيخ عماد الدين بن العفيف رحمه الله: ولا بدّ من تناسب الشكل والنقط وتناسب البياضات في ذلك للحروف.
|